الأحد
2023/04/09
آخر تحديث: 10:27 (بيروت)
مكتبة الوجوه
الأحد
2023/04/09
حي في دمشق
ترك الروائي السوري خيري الذهبي، الذي غادرنا صيف 2022 في فرنسا، مجموعة من المقالات غير منشورة. وتقوم "المدن" بنشر مختارات منها بالاتفاق مع عائلة الكاتب.
بعد المقال الأول، والثاني، هنا الثالث:
في كل مكان عشت فيه كان أول شيء أقوم به هو البحث عن مكتبة، أو أي مكان تتجمع به الكتب، سواء كانت مكتبة خاصة أم عامة أم مكتبة مسجد أم كنيسة أم جامعة. ولسبب ما أجهله كانت الكتب تشكل لي أماناً ما، ومستنداُ أرخي إليه ظهري بأمان، فقد كانت هي الحيز الآمن الذي أركن إليه في حالات اليأس و الغضب و الضياع.
في كل مكان عشت فيه كان أول شيء أقوم به هو البحث عن مكتبة، أو أي مكان تتجمع به الكتب، سواء كانت مكتبة خاصة أم عامة أم مكتبة مسجد أم كنيسة أم جامعة. ولسبب ما أجهله كانت الكتب تشكل لي أماناً ما، ومستنداُ أرخي إليه ظهري بأمان، فقد كانت هي الحيز الآمن الذي أركن إليه في حالات اليأس و الغضب و الضياع.
عشتُ في بيت قارىء فالوالد كان مثقفاً إضافة إلى كونه مدرساً يعمل في سلك التعليم، كان يملك مكتبة منزلية هائلة، كانت بوابتي الأولى إلى عوالم حياتنا الصاخبة، تلقيت تعليمي في دمشق وتهت في أوروبا ثم تخرجت في القاهرة حاملاً الإجازة في اللغة العربية أما دبلوم التربية فمن جامعة دمشق، عملت في التدريس في سورية والجزائر، وأول رواية كتبتها كنت في الثامنة عشرة ولم أنشرها، أذكر طفولتي في حي القنوات بدمشق حيث أصر الوالد على وضعي في مدرسة خاصة في الطرف الآخر من دمشق في حي (النوفرة) وكان علي أن أقطع دمشق يومياً أربع مرات من البيت إلى المدرسة التي كانت على دوامين صباحي ومسائي وأنا بعمر الست سنوات، كنت أقوم بهذه المهمة التي رأيتها وقتها شاقة جداً.
لكن بعد أن كبرت وتفهمت الأمر اكتشفت كم كنت محظوظاً حين كنت أعيش دقائق المدينة يومياً وكانت ملاعبي إذا ما أردت اللعب، ألاعبُ الحمام في الجامع الأموي والأسماك الحُمر في بحرة "نور الدين الشهيد" هناك حيث حملت طفولتي الكثير من المتعة، الآن وحين أذكر الجامع الأموي، أذكر قبر النبي (يحيى) الذي كان مزاراً لمعظم الطوائف الإسلامية ولكل مسيحيي العالم، الآن فقط أدرك أن ما كنت أراه في محيط الجامع عادياً، كان شيئاً استثنائياً لا مثيل له في العالم فليس هناك في العالم كله معبد يقبل المذاهب والأديان كلها في أحضانه (لكم دينكم ولي ديني). مع هذا الكم من الوجوه التي تعبر أمامي وأمام غيري بالطبع، بقصصها وأحاديثها وشكواها ونبلها وخستها، الحب والكره والخصام والغيرة والوفاء. قصص وقصص وحكايات لناس تعبر وتسير على قدمين حين كنا نتفرج.
حين أقارن طفولتي بطفولة ابني وهو كاتب أيضاً أجد أن طفولتي أكثر غنى وثراءُ بكثير فهو نشأ في بيت مغلق مساحته معروفة، غرفته معروفة، بينما نشأت أنا في بيت مليء بالتاريخ والأفكار فهنا ولدت خالتي وهذا المكان عاشت عمتي، وها هنا أرواح الأجداد التي تشتاق لأحفادها فتأتي على هيئة فراشات طالما نبهنا الأهل على عدم إيذائها فدمشق لم تكن قد أخذت شكل المدينة المنفصل عن الريف فالبساتين تتداخل مع المدينة، والطبيعة هي عنصر أساسي في دمشق، النهر والشجر والطيور.
في طفولتي كنت أشاهد الحساسين تغني على أشجارها والسناجب تقفز وتعود إلى البساتين، أثر كل ذلك على حياتي وذاكرتي، وكنت أنا كالفتى المتوحد فأخي الذي يكبرني بـ 7 سنوات والأصغر مني يصغرني بـ 11 سنة، فكانت تربيتي خاصة نتيجة وفاة الكثير من الإخوة قبل مجيئي، فعشت وحيداً عن أخوتي متسكعاً في البساتين وبين الأشجار، هارباً إلى أنهار الغوطة، أمضي الساعات أتأمل الطبيعة بأشجارها وطيورها ولقالقها التي كانت تزورنا، أبو زريق وأبو الفول... كلهم جوالون أعزاء على نفسي وذاكرتي.
تجاربي الحياتية كانت حاضرة في مواقع عديدة من أعمالي الروائية، وشكلت ركائز لعوالم وشخصيات هامة، مثلاً في طفولتي كان هناك امرأة تزور أمي في بيتنا، تدخن السكائر اللف وتتربع وهي تشرب قهوتها، تتنهد وتتحسر على الدوام، أما فضولي الذي كان دائماً بلا حدود يلح علي لأعرف ما الذي يجعل هذه المرأة في حالتها تلك وما الذي يجعل أمي تصر عليها، حتى تجرأت وسألت عن قصتها تنهدت أمي وقالت (الله يعين العباد) وكان علي أن أنتظر سنوات حتى أشب وتكهل أمي وتموت تلك المرأة فحدثتني أمي عن قصة غرام عجيبة عاشتها تلك المرأة مع شاب يصغرها بالعمر ابتزها وابتزلها وأهانها ثم تركها للوحدة القاسية، وجه هذه المرأة بالذات لن أنساه ما حييت فلقد كانت البذرة التي صنعت منها شخصية خالدية في رواية "حسيبة"، لأنه في بلاد الشام بلاد الدكنجية لا يحبون المغامرات الكبرى، فقصص الغرام تبقى حبيسة الوجوه والبيوت، والمرويات تبقى سراً حتى لا يظهر ذلك النموذج المتمرد الذي يكسر قانون الدكنجية الذي يرفض المغامرة، أما قصص الغرام التي يتداولونها هي قصص يقولون أنها بدوية أتت من المساحات المفتوحة حيث الفرسان والبطولة والخيل والليل، هناك يمكن أن ترتكب مثل تلك الخطيئة، خطيئة الحب مثل قيس ولبنى - أو عنتره وعبله- أما هنا فكل شيء لدينا بحساب أولئك من يساومون على القرش والليرة، لا يمكن أن يغامروا مغامرة الحب الكبرى وأقصد بلاد الشام، من إقليم ديار بكر إلى عسقلان، إنها بلاد الدكنجية بامتياز، لذلك فـ"خالدية" خانم علقت في ذاكرتي وحاولت أن أصنع قصة حب خائبة ككل قصص الحب الكبرى.
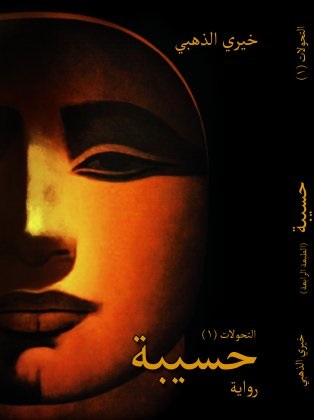
امتهنت قراءة الوجوه ساعتها، فكنت حينما يعز علي التقاط الكتاب، كنت أعمد إلى الشوارع والأسواق، أنتحي بقطعة سمسمية، وأراقب وجوه الناس في الأسواق، أو أسترق السمع لأب وابنه يفترشان زاوية من أجل وجبة الغداء في أحد أسواق المدينة العتيقة، وهناك كان البوح ممكناً، بوح الألم والوجع، فكل إنسان يخرج من بيته وسوقه وعمله يصبح غريباً والغربة تحتاج مناجاة، وكنت هناك دوماً ألتقط تلك المناجاة وأتعلم كل ما لم تعلمني إياه الحياة في الغرف والكتاتيب والمدارس والجامعات وفرنسا ومصر وكل كتب العالم، هناك تعلمت قيمة الألم والدمع والقهر والسعادة، أفرح معهم وأضحك لضحكهم.. حتى أن أغلبهم كانوا يتنبهون لوجودي، طفل يافع صغير أجلس وحيداً، فيظنون أنني جائع حتى يدعوني لمشاركتهم وجبتهم الصغيرة، فألبي الدعوة وألتقط التماعات الأعين وخفقات القلب.
هناك كان مختبري الروائي الأول، ولا يزال هو نبع الحكايا التي لم تروَ بعد.
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها